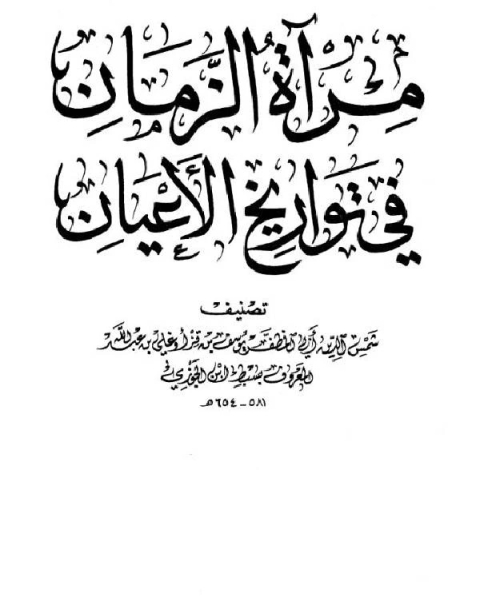كتاب الحوار النصراني الإسلامي تاريخه، وأهدافه وغاياته، والموقف الشرعي منه
تحميل كتاب الحوار النصراني الإسلامي تاريخه، وأهدافه وغاياته، والموقف الشرعي منه pdf 2007م - 1443هـ إذا كان التعايشُ يعني بلوغ أدنى مستوىً من التوتر في العلاقات بين طرفين متنازعَين فإن الحوار يغدو وسيلةَ بلوغ هذا المستوى، وذلك لكون كلمة الحوار في ذاتها تعني تبادل وجهات النظر بقصد الوصول الى حَدٍّ أدنى من التقابُل والإتفاق حولَ المفاهيم والمُدركات المشتركة. وفي هذا الصدد يَرِدُ تطبيقان مختلفان للحوار، أولهما يشملُ الأُسلوب المنطقي في البحث عن الحقيقة، وهو في الأصل منهجٌ فلسفي يتضمّنُ الجدال بين طرفين بقصدِ الوصول الى الحقيقة غير القابلة للإختلاف فيها مجدداً. أما ثانيهما فهو الحوار بمعنى المسلك التفاوضي للتعامل الدولي، ولا يغدو الحوار فيه لغةَ الوصول الى الحقيقة وإنما وسيلةً للحصول على تنازلات. وبالرغم من الإختلاف فإن كلا التطبيقين يشتركان في وجودِ طرفَين يتصارعان بأساليبٍ خفّية، تستّتِرُ خلفها الرغبةُ في تطويع وإستيعاب الطرفِ الآخر. ومن المعلوم أيضاً ضمن نطاق الحوار أنَّه ذو نماذجٍ عديدة، منها السياسي والاقتصادي فضلاُ عن الديني، لكن أكثرها دائرٌ بين طرفَين أحدهما مسلمٌ شرقي والآخر نصراني غربي. وطالما إن الحوار النصراني الإسلامي ليس إلا انعكاساً لفاعلية الظاهرة الدينية دولياً ولا سيما المسيحية الغربية والأصولية الاسلامية، فإن الأمرَ يستدعي التساؤل الآتي: أيٌّ من هذين التطبيقَين يقع ضمن حدودهِ الحوار المسيحي- الإسلامي؟ وقبيلَ الخوضِ في تصنيف هذا الحوار وتبيانِ موقعهِ في نطاق التعامل الغربي، حَرّيٌ بنا إتخاذ عِدّة خطوات مسبقة، أولاها التعرّف على الجديدِ في موقفِ المسيحية الغربية من الإسلام، وثانيهما معرفةُ البواعث التي أوجدَتهُ. ففي سياق مفهوم الحوار نجد أنَّ فكرة الحوار قد أُستخدمتْ نظرياً ولأول مرّة عام 1949 من قبل المُنصِّر هنري نوسلي Henry Nossle في كتابه المعنوَن "الحوار مع الإسلام"، بيد أن طابعَهُ العام ظل تقليدياً بصددِ آلية انتهاج الحوار. وقد عمد مجلس الكنائس العالمي بين عامي 1955 – 1970 الى إجراء دراسات تمهيدية في هذا الشأن تحديداً، وحملتْ عنوان "كلمة الله وحياةُ الإنسان العقيدية"، إلا إن هذا التوجّه الجديد لقيَ معارضةً داخلية، برزتْ على نحو واضح في مؤتَمري المجلس اللذين تمّ عقدهما في نَيروبي بكينيا عام 1975 وفانكوفر بألمانيا عام 1983. فقد عارضت الأصولية البروتستانتية انتهاج الحوار مع المسلمين، واعتبرته "خيانَةً للرسالة المسيحية وباباً مفتوحاً أمام التوليف". بيد أنَّ كل ذلك لم يمنع معظم الطوائف والمذاهب المسيحية من الإتفاق حول محاور وأطراف الحوار، بحيث أنَّ الحوار الديني في منظورهم لا يشمل المسلمين فحسب، بل تَمّ تصنيفُهُ الى عِدّة أنواع تبعاً لديانةِ الطرف الآخر، ولعّل أهمها الآتي ذكرهُ: 1- الحوار داخل النطاق المسيحي، ويتعلّقُ بتمييز وتحديدِ الإختلافات المذهبية ما بين الكنائس النصرانية بقصدِ الإتحاد. 2- الحوار مع كافة المؤمنين غير النصارى ويشملُ ذلك المسلمين واليهود. 3- الحوار مع اصحاب الديانات الأُخرى. وفي هذا الخصوص ينبغي تبيان موقف المسيحية الغربية ولاسيما الكاثوليكية من الإسلام. حيث نجد كون دراساتها المعاصرة عن الإسلام تتضمّنُ إتجاهات عديدة بصدد نشوء الإسلام وعقيدتهِ ورسالته. إذ أنَّ الإتجاه الاكثر إنفتاحاً فيهِ يُمثِّلهُ المستشرق لويس ماسينون وأنصارُهُ الحاليين، ويُطلَقُ عليه إتجاهُ الحدّ الأعلى في الاعتراف بالإسلام. حيث "يعترفُ أنصارهُ بصورةٍ أو أًخرى بالطابع الإلهي للقرآن، وإنطلاقاً من هذه النقطة بالذات يُناقشون الرفضَ القُرآني للعقائد المسيحية الأساسية مثل الثالوت أو ألاقانيم الثلاثة والتجسّد الإلهي، وينظرون الى هذا الموقف الرافض على إنّهُ موقفٌ نسبي وغير مطلق، ويروَن فيه نوعاً من رَدِّ الفعل السلبي من طرفِ الإسلام على فكرةِ الثالوت والإنشقاقات والخلافات الطائفية في المسيحية ذاتها. أما "الإتجاه المضاد في الدراسات الكاثوليكية... فيتمثّلُ في التيار المنغلق... ويُطلَقُ على أتباعهِ أصحاب الحدّ الأدنى في الإعتراف بالإسلام... الذين يُتابعون تفسير الإسلام وفق أسوء الإطروحات التقليدية للقرون الوسطى"، وبينهما يوجد التيار الوسط وآراؤهُ قريبةٌ من "الموقف الرسمي للكنيسة في الحوار مع المسلمين، ورغم إن موقفَهُ بالنسبةِ لنبوة محمد والطبيعة الإلهية للقُرآن اكثرُ تحّفُظاً" لكن أنصارهُ يعتقدون بضرورة "الحوار والتقارب مع الإسلام في الميادين الإجتماعية والسياسية والثقافية والروحية، ويستبعدون المنطقةَ التي لا تُمسّ... ونعني بها المسائل المتعّلِقة بالأُسس واليقينيات العقيدية في كِلا الدينين". ولا يعكِسُ واقع الإختلاف النسبي بين هذه الإتجاهات الثلاثة الا حقيقةَ الإختلاف القائم ما بين رجال الدين (اللاهوتيين) والمستشرقين. فقسمٌ منهم وتحديداً المستشرقين يميلون بصورةٍ كبيرة الى إبراز الجوانب المتشابهة بين الديانتين، فيَرَونَ الإسلامَ أحدَ تفرُعات التقاليد التوراتية، بينما يُركّزُ غيرهم على الإختلافات الجوهرية بحيث "يَرَونَ الإسلام عقيدة أقربُ ما تكون الى الدين الطبيعي بحكم تشكُّلهِ خارج التراث اليهودي – المسيحي مع إنّهُ اقتبَسَ أشياءاً كثيرة من ذلك التراث" وفقاً لمنظورهم. فتمخّض عن هذا الاختلاف النسبي في الآراء داخل الفاتيكان إعتماد الكنيسة الكاثوليكية الحوارَ مع المسلمين، إستناداً الى موقِفٍ آتخذّتهُ إبان إنعقاد المَجمع الفاتيكاني الثاني "1962–1965". ويتجلى هذا الموقف في نَصّ تصريحها الآتي: ((إنَّ الكنيسةَ تنظُرُ بعين الإحترام الى المسلمين ايضاً الذين يعبُدون الله الواحد الحيّ القيوم الرحيم، والقادر على كُل شيء، خالقَ السماء والأرض. الذي كلّم الناس وهم بدورهم يخضعونَ لأوامرهِ الغيبية بقلوبٍ راضية كما خضعَ له إبراهيم والذي يشغل مكانَةً مميزةً في العقيدة الإسلامية. إنَّ المسلمين يُجِّلون المسيح بوصفهِ نبياً وإن كانوا لا يعترفون به إلهاً، ويحترمون أمَّهُ مريم البتول ويذكرونها بإخلاصٍ أحياناً. ثم إنَّهم يرتجون اليوم الآخر، يومَ يجزي اللهُ جميع الناس بعد البعث، وهم بالتالي يُقدِّرون الحياة الأخلاقية ويعبدُن الله بالصلاة والزكاة والصيام بخاصة. وإذا نشأتْ عبر القرون خلافات وعداوات غير قليلة بين المسلمين والمسيحيين، فإن المجمّعَ الفاتيكاني المقدّس يدعو الجميع الى نسيانِ الماضي ومحاولة الشروع بالتفاهم المتبادل الصادق، والعمل المشترك لنُصرةِ وتأكيد العدالة الإجتماعية والقيم الأخلاقية والسلم والحُرية لجميع الناس)). ويُلاحَظ في هذا النصّ أنَّ الرؤية الكاثوليكية الى الحوار الديني بعامة تُفّرِقُ بين شكلين رئيسين، أحدهما نظري ويشمل الجوانب العقيدية المشتركة، والآخرُ عمليٌ متمثّلٌ بالتعاون في المجال الإجتماعي، ودليلُ ذلك إحتواءُ التصريح على أُطروحتين فكريتين: أولاهما وصفٌ إيجابي للعقيدة الإسلامية وثانيهما آفاقُ الممارسة الإجتماعية المشتركة، بحيث إن الاطروحة الاولى قد أوْلَتِ الإهتمامَ بما يربط الديانتين بدرجةٍ أو أُخرى، وبموجبها يكون المجمع قد حدّد ميادين "الحوار العقيدي بالتوحيد والتقليد الإبراهيمي، والدراسات المسيحية لدى الجانبيَن والدراسات المَريَمية ومسائل الآخرة فضلاً عن التعاليم الأخلاقية والعبادات. في حين أنَّ الأطروحة الثانية تشمل ميادين العدالة الإجتماعية والسلم والحرية، وحسب تعبير أليكسي جورافسكي "إذا كان نَصُّ التصريح يبدو للوهلِة الأولى عامّاً جداً ومقتضَباً أو بالأحرى متحّفِظاً، الا إنّهُ رغم ذلك يتطرق الى النواحي الاكثر أهميةً في العلاقات الإسلامية- المسيحية على الصعيد العقيدي". ومعنى إشارة جورافسكي الى ان الموقف متحّفِظ، لا يخرج عن مسألة عدم الإفصاح عن حقيقة الموقف النصراني من نُبوةِ الرسول محمد (ص)، وفي المقابل من ذلك أورد التصريح مسألة إعتراف المسلمين وتقديرهم للمسيح بن مريم (ع)"وإن كانوا لا يعترفون به إلهاً"، الأمر الذي يعكس صواب منظور المستشرق مكسيم رودنسون في قوله بهذا الشأن، "إنَّ الحركة العالمية للإتحاد الكنسي (المَسكونية)، لم تتنازل عن موقفها بأنها المالكة الوحيدة للحقيقة كُلها وإنهُ يتوجّبُ عليها أنْ تجلِبَ الضالين اليها. ورغم ذلك فقد تخلّتْ عن ممارسة الضغط الزائد في المجال الروحي واعترفتْ بأن أصحاب العقائد الأُخرى شُركاءٌ في الحوار ويمكن أن يتحّولوا الى حُلفاء"... هذه الثورة في التفكير جعلتْ التقييم المسيحي لمحمد (ص) مسألة حسّاسة، فلم يَعُدْ بإمكانهم الزعَم الكاذب بأنَهُ محتالٌ شيطاني كما كان عليه الحالُ في العصور الوسطى. وفي الوقت الذي نجدُ فيه مُعظَم المفكرين المسيحيين الذين يهتمّون بالمشكلة يُعلِقون الحكم بحذر، فإننا نجد بعض الكاثوليك المتخصصين بالإسلام يعتبرونَهُ عبقرياً دينياً بل يذهبُ بعضهم الآخر أبعدَ من ذلك، فأصبحوا يتساءلون عن ما اذا لم يكن بالإمكان إعتباره بطريقةٍ ما نبيّاً ما دام القدّيس توما الإكويني يقول بالنبُوة التوجيهية، التي لا تعني بالضرورة العصمةَ والكمال". وهنا ينبغي التمييز بين المنظورَين الإسلامي والمسيحي بخصوص مفهوم النُبوة. ففي المنظور الإسلامي، نجد أنَّ المشهور في الفَرق بين النبي والرسول يتمثل في أنَّ الأول هو الذي أوحيَ إليه بشرع "أي بأحكام" سواءً أُمِرَ بتبليغهِ والدعوة إليه أم لا. فإنْ أُمِر بذلك فهو نبيٌ رسول. مما يعني أن الفرق الأساس بينهما يتجسّدُ في الأمر بالتبليغ من عدمهِ، فالنبي أعّمُ من الرسول إصطلاحاً، بحيث يمكن القول إن كل رسول هو نبي وليس كل نبي رسولاً. أما في المنظور المسيحي، فنجد أن النُبوة عموماً هي "رئاسَةٌ روحية ورسالةٌ إلهية تٌنْبيءُ بما يريدهُ الرّب وقد اكتملتْ النبؤة بمجيء المسيح"، لكن المسيحيين بعامة يسلمون بإستمرار الرسالات الإلهية بفضل الروح القُدس بحيث يختارُ اللهُ تعالى بعضَ عبادهِ وينتدبهم لنقل البشارة أي الإنجيل الى العالمين. وإذا كان ذلك هو أصلُ التفريق بين نوعَي النبوّة، فإنّهُ يعكس من جانبٍ آخر إستمرارية نفي النبوة الحقيقية عن النبي محمد (ص). مما يَدُلُّ ذلك على كون الموقف الكاثوليكي بشكلٍ عام والذي أُستُنِدَ عليه بُغية الحوار ليس جديداً في جوهره وإن أوحى شكلُه بالإيجابية. .
عرض المزيد